1. لنبدأ من البدايات. متى شعرتِ أن أدب الأطفال ليس مجرد نوع أدبي، بل بيت داخلي تنتمين إليه؟ وكيف تشكّلت علاقتكِ الأولى مع هذا العالم؟
تشكّلت علاقتي الأولى مع هذا العالم السحري عندما كنت طفلة صغيرة، حين كانت أمي تهدهد، أو تهلّل، أو تُغني لنا وفق مزاجها. كنت أستمع إليها وأبكي بصمت؛ فعندما تفرح كانت تهدهد، وعندما تبكي كانت تهلّل.
كانت تهدهد لي وأنا أجلس قربها، تجدّلُ ضفائري الطويلة، تكنس غبار الوقت، تلمّ الغسيل عن سطح الدار، ترتق جواربنا وملابسنا، وتشاركنا تفاصيل يوميّاتنا الصغيرة. لكنها لم تكن تهدهد بمفردها؛ بل علّمت أختي وعلّمتني أسرار الهدهدة، وكان صوتها رقيقًا وعميقًا... كصوت الماء.كلماتها كانت جميلة، ولغتها سليمة. وهكذا زرعت فيَّ، وفي إخوتي، ثروة لغوية غنية منذ نعومة أظافرنا، رافقتني مدى الحياة.
"اللغة السليمة ليست جينات نتوارثها بالسليقة، أو نتعلمها على مقاعد الدراسة فحسب؛ بل هي مرافقة لغوية تبدأ بالقصّة والأغنية، والاحتواء والحنان."
وهكذا، أصبحت الهدهدة والتهاليل طريق النحل الذي حملني إلى عالم الحكايات...ذلك العالم الذي غدا بيتي، وملجئي، ومتنفسي الوحيد، في مجتمع محافظ
مغلق آنذاك، يفتقر للكتب والمكتبات والقرّاء على حدٍّ سواء.
وكان والدي، رحمه الله، هو الوحيد الذي أدرك شغفي؛ كان يصطحبني إلى مدينة عكا، لأشتري الكتب من إحدى المكتبات الصغيرة في أول السوق القديم، بنقود كنت أدّخرها من مصروفي الضئيل.
ما زلت أذكر الساعات الطويلة التي كنت أقضيها تحت الشمس الحارقة أو في البرد القارس، فقط لأستعير الكتب من المكتبة المتجوّلة القادمة من حيفا.
كلّ شيء يتعلق بالكتابة كان يناديني، وكأن للكتاب أجنحة تحملني نحو الأبدية، ونحو عوالم خيالية أثْرت خيالي ولغتي، غلّفت روحي، وشكّلت هويتي الإنسانية.
وكانت رواية "لمن تقرع الأجراس" أول رواية قرأتها في الصف السادس. بعد أحداثها المأساوية، نذرت قلمي أن أكتب من أجل السلام العالمي.ومنذ ذلك الحين، لم أتوقف عن المطالعة... ولا عن الكتابة.
2. في "ماما كَراكيب تصنع الأعاجيب"، تحضر شخصية أمّ مدهشة تجمع الفرح من الفوضى وتحوّل المهمل إلى مدهش. هل كانت هذه الشخصية انعكاسًا لذاكرةٍ ما، أو لامرأةٍ عرفتها؟
"ماما كراكيب" هدية لكل النساء: لربّات البيوت، وللمرأة العاملة، القوية، الشامخة، التي تنشر الفرح والسعادة في كل القلوب.رغم أنها لم تحظَ بتعليم أكاديمي، ولم تستند إلى كتف أحد، تبقى بطلة قصّتي امرأة عصامية، متفائلة، تحمل رسالة "عالمية"؛ رسالة الحفاظ على بسمة البيئة وجودتها.
ورغم التنمر الإلكتروني الذي تعرّضت له هي وابنتها رانية، ورغم نظرات الآخرين، لم تتنازل عن حلمها، ولا عن شغفها، ولا عن رسالتها.بل علّمت ابنتها – التي حفّزتها لتكون شريكة لها في هذا الإنجاز العظيم – فن التجاهل، وعدم الاكتراث بأقوال الناس، ما دامت تحمل رسالة محبة وشغف تعجّ بالخير.
حوّلت هذا التحدّي وهذا التنمّر إلى منحة وفرصة للنمو والإبداع والازدهار، ومشروع عظيم يساهم في الحفاظ على جودة البيئة.وبفضل شغفها، استطاعت أن تتفوّق على كل الأمهات؛ فهي ربّة البيت المدهشة، التي لم تفتنها قشور الحياة، بل كانت عفويتها وتفاؤلها مفتاحًا لكل القلوب.
ألا تشبه "ماما كراكيب" أمهاتنا وجداتنا؟
أولئك اللواتي عملن في البيادر، وعلى دكّة النورج، لوّحن رغيف الصاج، وجمعن الحطب، وطرّزن جهاز العروس تحت ضوء قمر مبدر.أبدعن في فن الحياكة والتطريز، ولي القش، وأتقنّ الكعك والطبخ، رغم شظف العيش وشح الموارد.
ما زالت عالقة بذاكرتي قصة إحدى السيدات، التي أخبرتني أنهم خاطوا بدلات العيد لأولادهم من شوادر الخيام التي نصبها الجنود الإنجليز إبان الانتداب البريطاني على فلسطين.
"ماما كراكيب"، التي أعتزّ بها كثيرًا، تعكس شخصية المرأة الحكيمة، التي لا تصنع من الحبّة قُبّة، بل تترفّع عن قُبح "العالم" وصغائر الأمور بسعة صدرها وحكمتها.
تلمس جمال الأشياء بروحها وقلبها وجميع حواسها؛تحوّل التراب إلى غمار قمح، والقفر إلى بستان، والوردة إلى حديقة.هي المرأة عميقة الفكر، خفيفة الروح، لا تأبه لثرثرة الناس، صاحبة الهمّة العالية والأخلاق الراقية.
ليس شرطًا أن "تفصّل للبرغوث لباسًا" – كما كانت تقول جدّتي – ولا أن تصنع مركبة فضائية،لكنها تدرك قيمة مواهبها وتعزّزها في مجتمع تقليدي مادي، يقدّر كل شيء من منظور ماديّ محض، ويكرّم المرأة المنتجة ماديًا، لا فكريًا أو إبداعيًا.
وهذا أمر مؤلم، حوّلنا إلى مجتمعات مستهلكة، من قيمة الإبرة... حتى السيارة.
أما كتاب "ماما كراكيب" الذي كتبته بصورة فكاهية، فهو يعزّز مكانة المرأة، ويحمل رسالة مبطنة إلى مجتمعاتنا – سواء كانت يهودية أم عربية – التي تُقدّس الشهادات، لا الكفاءات،ولا تعير أهميةً لقدرة المبدع على التغيير، وعلى أداء مهامه بمهنية، وتقنية، وإنتاجية.

3. في "هدايا صغيرة"، نلحظ حسًّا تأمليًا يُعيد للبساطة هيبتها، ويشبه في لغته الهايكو الياباني. ما الذي قادكِ إلى هذه اللغة المختزلة؟ وهل كانت محاولة للكتابة عن الطفل، أم معه؟
كم هو سؤال عميق ومؤثّر. بل هي محاولة للكتابة مع الطفل، دون أدنى شك، وليس عنه.
الكتابة مع الطفل تزيد التجربة الكتابيّة عمقًا، ومصداقيّة، وعفويّة. ولذلك ارتأيت أن أكتب مع الطفل، خطوة خطوة، حتى نصل لبرّ الأمان. أشعر بفرحه وحزنه،
أستبر أغوار نفسه، أكتشف مخاوفه، أضحك وأبكي معه، حتى يتعلّق الطفل بأبطال القصّة وينضج معهم.
من خلال كتابتي مع الأطفال، أقولها وبكلّ تواضع: استطعتُ لمس روحهم، بكل أمانة وشفافية، دون وعظ أو زجر أو إرشاد، بل ببساطة ولطافة، وضحكة كبيرة أرسمها على وجوههم البريئة، دون جواز سفر أو استئذان.
وبالنسبة لشعر الهايكو، أنا لم أختر هذا النمط بالصدفة، لأنه يُعتبر نوعًا شعريًا مثاليًا للأطفال.فهو شعر الطبيعة الذي يقرّب الطفل من بيئته ويعزّز علاقته بها.
وفي اليابان، يبدأون بتعليمه للطلاب منذ المرحلة الابتدائية؛ حيث يتيح لهم التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم الجيّاشة والعميقة، بألفاظ سهلة، وبلغة مختزلة بسيطة، من خلال وصف الطبيعة والتأمل في جمال الكون.
هذا النوع الشعري يُشجّع الأطفال على الإبداع، والاستمتاع بالشعر، والتعلّم من أبسط الأشياء.
واو.. عاد الربيع!
ما عادت الفزّاعة
تُخيف الطيور.
***
صباح بهيّ
ورود تتطاير في السّماء..
فراشات ملوّنة.
***
الوردة التي سقتها كلّ الصيف..
تُزيّن شعرها الآن..
4. الكتابة للطفل تضعكِ دائمًا بين خيارين: الجمال والبُعد القيمي. كيف تتعاملين مع هذا التوتر؟ وهل تشعرين أحيانًا أن الرسالة تهدد الحكاية؟
من خلال كتابتي للأطفال، حاولت جاهدًا عدم الخلط بين جمالية الحكاية والرسالة، وعدم إلغاء الواحدة على حساب الأخرى.
الكتابة التقليديّة الموجّهة تطلب منّا أن يحمل الكتاب رسالة قبل كلّ شيء، وهذا يُعتبر شرطًا أساسيًا، حسبما يعتقده البعض، كي يكون الكتاب ناجحًا.
وأظنّ أن هذا يُعدّ تأطيرًا للحكاية الممتعة، المُسلية، التي يُريد الأولاد أن يسمعوها.ونحن، ككُتّاب للأطفال، نُضطر أحيانًا إلى كتابة أدب مزدوج – للأسف الشديد – يرضي ذوق الأهل قبل ذوق الصّغار.
لكنّني، وبكلّ تواضع، كسرت كلّ التابوهات التي تحدّ من رؤيا الطفل، وتُشعره بالدونيّة، وتحثّه على لعب دور "الولد الشاطر" الذي يسمع الكلام، ويستيقظ باكرًا، ويفرش أسنانه.
تخلّصت من هذه العقد.
أكثر ما يهمّني هو أن يستمتع الصغار بحكاياتي، أن يضحكوا ملء قلوبهم الغضّة، وأن يردّد الفضاء صدى ضحكاتهم.أن يحفر النص عميقًا في وجدانهم، ويوصل إليهم أعمق رسالة.
"القصة الممتعة، لا ينساها الطفل، وهي تساعد على تقوية ذاكرته، وفهم تسلسل الأحداث."
وكان "فستان ماما كراكيب" أكبر مثال على ذلك.وكم كان يُطربني صوت ضحكاتهم عندما كنت أقرأ لهم القصّة!
5. ككاتبة من الداخل، تكتب للأطفال من قلب مجتمع معقّد ومتعدّد الهويات، ما التحديات التي تواجهينها؟ وهل تحاولين بناء طفل محدد الهوية، أم تكتبين له لتفتحي له أبوابًا أوسع؟
من خلال كتابتي للأطفال، حاولت عدم الخلط بين جمالية الحكاية والرسالة، وعدم إلغاء الواحدة على حساب الأخرى.الكتابة التقليديّة الموجّهة تطلب منّا أن يحمل الكتاب رسالة قبل كلّ شيء، وهذا يُعتبر شرطًا أساسيًا، حسبما يعتقده البعض، كي يكون الكتاب ناجحًا.
وأظنّ أن هذا يُعدّ تأطيرًا للحكاية الممتعة، المُسلية، التي يُريد الأولاد أن يسمعوها.ونحن، ككُتّاب للأطفال، نُضطر أحيانًا إلى كتابة أدب مزدوج – للأسف الشديد – يرضي ذوق الأهل قبل ذوق الصّغار.
لكنّني، وبكلّ تواضع، كسرت كلّ التابوهات التي تحدّ من رؤيا الطفل، وتُشعره بالدونيّة، وتحثّه على لعب دور "الولد الشاطر" الذي يسمع الكلام، ويستيقظ باكرًا، ويفرش أسنانه.
تخلّصت من هذه العقد.
أكثر ما يهمّني هو أن يستمتع الصغار بحكاياتي، أن يضحكوا ملء قلوبهم الغضّة، وأن يردّد الفضاء صدى ضحكاتهم.أن يحفر النص عميقًا في وجدانهم، ويوصل إليهم أعمق رسالة.
"القصة الممتعة، لا ينساها الطفل، وهي تساعد على تقوية ذاكرته، وفهم تسلسل الأحداث."
وكان "فستان ماما كراكيب" أكبر مثال على ذلك.وكم كان يُطربني صوت ضحكاتهم عندما كنت أقرأ لهم القصّة!

6.كيف تفهمين اليوم فكرة "رسالة" أدب الأطفال؟ هل يجب على القصة أن تُعلِّم؟ أم أن التعليم يحدث في مكان آخر غير المقصود؟
أدب الأطفال رسالة إنسانية ثمينة، شأنه شأن باقي الآداب العالمية، بل هو من أصعبها إنجازًا وتنفيذًا.ويجب على المؤسّسات أن تعي ذلك، وأن تبدأ بتذويت أهميّته وقيمته في عقول الأهالي قبل أطفالهم.
وأجد تقصيرًا كبيرًا في هذا الشأن من قبل وزارة التربية والتعليم، التي تُعزّز كلّ شيء سوى الكتاب، ولا ترصد أي ميزانية من أجل دعم الكتّاب وإنتاجهم الأدبي.
حتى المكتبات في مدارسنا، غالبيّتها خالية، مهملة، يعلوها الغبار، بسبب البرامج والمواد الكثيرة التي تفرضها الوزارة على المعلمات، دون أن تُكرّس حصة واحدة للكتاب أو للمطالعة، ودون أن تسعى لتعزيز هذه القيمة في نفوس الطلاب عن طريق استضافة الأدباء والاستفادة من خبراتهم.
ولذلك، وجدت هناك ضعفًا كبيرًا لدى الطلاب في التعبير الشفهي قبل الكتابي.
للأسف الشديد، مكتباتنا مهجورة وكتبُنا يتيمة، ليس بسبب قلّة جودتها أو أصالتها، بل بسبب قلّة الوعي والاهتمام من الوزارة، والمدارس، والمؤسّسات، وعدم توجيه الأهالي، بدءًا من الحضانات وحتّى الصفوف العليا.
الغالبية الساحقة تُلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي والعولمة الحديثة، لكنه عذرٌ أقبح من ذنب.
طمس هويّة الكتاب والكتّاب، وعدم الاهتمام بهذا المجال، بدأ قبل هذه الثورة المعرفية، حين أصبح التعليم يهدف فقط إلى الحصول على الشهادات، ونيل المناصب والمكافآت المادية.
7.الجوائز التي حصلتِ عليها — هل منحتكِ دفعة ثقة؟ أم فرضت عليكِ مسؤولية أكبر؟ وهل فتحت لكِ أبوابًا في عوالم النشر المحلي والعالمي؟
بدون أدنى شكّ، فإن الجوائز التي حصلت عليها منحتني الكثير من الثقة والفخر بما أنجزته، وفي الوقت ذاته، جعلتني أشعر بمسؤولية أكبر تجاه ما أقدّمه لأطفالنا الأعزّاء.
لقد نلتُ شرف الكتابة لهذا العالم الطاهر، الشفيف، وأتمنى أن أبقى دائمًا عند حُسن ظنّهم.
وأخصّ بالذكر الكلية الأكاديمية العربية – حيفا، بمناسبة تكريمي عن كتابي"أبي وأمّي والكلبة فيكي".
كما أتمنى أن تحظى كتبي برعاية دور نشر عالمية، وبترجمتها إلى لغات أخرى، رغم أن دور النشر المحلية لم تُقصّر معي، بل تبنّت غالبيّة كتبي التي أصدرتها، وهذا طبعًا شرف عظيم لي.
وفي هذا السياق، أنصح كل من يرغب في التعامل مع هذا العالم الشفيف، أن يكتب من أجل متعة الطفل قبل كل شيء، وأن يثري خياله، بلغة سلسة تقرّبه من النص،أن يزرع الفكرة دون أن يفرضها...
فـهذه هي أكبر جائزة للكاتب.
8. في كتب الأطفال، النّصّ لا يكتمل إلا بالصورة. ما طبيعة علاقتكِ بالرّسامين والرسامات؟ وهل تشعرين أن التعبير البصري أحيانًا يُضيف، وأحيانًا يحدّ من رؤيتكِ الإبداعية؟
كلّنا شركاء في تكوين المعاني؛ فالعملية الإبداعية لا تكتمل إلاّ بالرسومات، والغلاف الجميل، وإخراج الكتاب في أبهى صورة - بشرط واحد: أن يكون التعاون بين الطرفين.
والحمد لله، حظينا برسّامين أكفّاء، خريجي دفيئة "حكايا"، التي أحدثت انقلابًا في عالم أدب الطفل، بفضل رعايتها للكتّاب والرسّامين على حد سواء.
وفي كتاب "هدايا صغيرة"، الذي أعتزّ به كثيرًا، نجحت الرسّامة الرائعة فاتن جريس جرّوس في أن تقدّم للأطفال، وبتقنية الكولاج، أجمل هدية، ملفوفة بشريط أحمر فاخر، يُكاد الطفل يفكّه قبل أن يفتح الكتاب!ليجد باقة من الهدايا الرائعة، تنتظره من أرومة الحياة ومفاتن الطبيعة؛ هدايا
مجانية، لا تحتاج إلى نقود ولا أوراق مالية، مرسومة بألوان زاهية تُبهر الطفل، ورسومات واضحة تغنيه حتى عن قراءة النص.
وقد ساهمت الألوان الهادئة، التي ركّزت على شخصية "ماما كراكيب"، في إنجاح الكتاب، بريشة الفنّانة المبدعة بروج بدير.
كما حظيتُ بتعاون كبير ومشرّف مع الرسّامة والمبدعة الكبيرة آلاء مرتيني، التي تدخّلت في بعض الرسومات في كتاب "جود يحلّق في الفضاء" و"حارة السّلام".وكان ذلك تعاونًا مباركًا ومثمرًا، أخرج الكتب بأجمل حلّة.
9. في زمن تُغري فيه الشاشةُ الطفلَ بكل أنواع التفاعل، هل ما زال لكتاب الطفل الورقي سحر؟ وكيف تحلمين بأن يُقرأ كتابكِ — في سرير، أم في صف، أم على مائدة حوار؟
كتاب الأطفال الناجح هو عالم سحري قائم بحد ذاته، كُتب بلغة حيّة، سلسة، بعيدًا عن اللغة الرسمية المبتذلة.
ورغم سحر الشاشات والمشتّتات، التي استحوذت على عقول البشر، وسلبتهم بصيرتهم قبل بصرهم، وقتلت فيهم روح الإبداع، وشتّتت شملهم -فلا بديل عن الكتاب، ولا عن لَمّة العائلة لمناقشة كتابٍ ما، في مجتمع فقد لغة الحوار، والنقد البنّاء.
أكثر ما يحتاجه أولادنا هو تعلّم فنّ الحوار، لا التلقين، الذي يُمارَس في مدارسنا – للأسف الشديد - ويُرغم الطلاب على الجلوس ساعات طويلة أمام المعلمة، دون السّماح لهم بالنطق ببنت شفة.
سواء قرأنا القصة للطفل في السرير، أو في الصف، أو مع العائلة، أهم شيء هو أن نعطيه مساحة للحوار والنقاش، وتفريغ مشاعره من خلال أحداث الكتاب،وأن نعزّز فيه قيمة التفكير النقدي البنّاء، ولغة الأخذ والعطاء.
10. كامرأة تكتب للأطفال، هل تشعرين أن لهويتكِ الجندرية حضورًا ما في نصوصكِ؟ وهل هناك مواضيع شعرتِ أنها تأخّرت عنكِ، أو ما زالت تنتظر وقتها لتُكتب؟
لم أشعر قطّ أن هويّتي الجندرية لها تأثير على ما أكتبه أو أقدّمه، سواء للصغار أو الكبار.
أنا إنسان، وأكتب بقلمٍ إنسانيّ، وحسٍّ روحانيّ.
الأدب الإنسانيّ الراقي يُقدّم عملًا جيّدًا لكلّ "العالم"، دون التقيّد بدين، أو جندر، أو جنسانية، أو حمولة.وصدقًا، أقول إنّ الأمومة أثّرت كثيرًا على كتاباتي؛ فقد خاطبتُ الجميع دون استثناء، وكأنّهم أولادي وأحفادي.
وأكثر شريحة أردتُ الكتابة لها، هي الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.ورغم صعوبة الأمر، لا توجد - حتى الآن - كتب تهتم حقًا بمشاعرهم، وتستحوذ على اهتمامهم، وتلمس أرواحهم.
أتمنى أن يمنحني الله عزّ وجلّ القدرة على الكتابة لهم ومن أجلهم.
11. أخيرًا، ما المشروع الجديد الذي يشغلكِ هذه الأيام؟ وهل من فكرة أو حلم لم يُكتب بعد، لكنه يرافقكِ في الصمت؟
أكثر ما يشغلني اليوم هو كتاب بنكهة الهايكو، للكبار والصغار، أعمل عليه منذ فترة.يشمل مواضيع شتّى، تتناول كل أسرار الخلق والجمال، ويستحضر قوة الوعي بكلّ شيء جميل يحيط بنا:كلّ ما تلمسه أيدينا، وتُنصت له آذاننا، وتُبصره عيوننا، ويحرك مشاعرنا وحواسنا.
هو شعر يختزل سحر الطبيعة الخالدة وتفاصيلها الصغيرة، ببضع كلمات...وهذا هو سحر الهايكو وسرّ نجاحه.
حلمٌ يرافقني أن أوفَّق في طباعته إلكترونيًّا وورقيًّا، وأن يكون متاحًا لكلّ أصدقائي القرّاء.أنا عضوة في عدّة نوادٍ ترعى هذا اللون الأدبي الرائع.
حلمي الكبير أن تتحوّل قصصي إلى ملّاءة مطرّزة بأزهار اللوز، أسدلها على الأطفال كل مساء، ليغفوا بأمان.
تسعدني لقاءاتي بهم في المدارس، حين يحدّثونني عن قصصي بلهفة وفرح، فابتسامتهم كنزي الحقيقي.
إن لم نروِ الجذور، كيف تنمو الأغصان؟نحتاج إلى جيل يؤمن بالاختلاف، ويوجّه طاقاته نحو الإبداع، لا نحو العنف والدمار.
أكتب قصصًا تُدافع عن الأطفال والفئات الضعيفة، من خلال منصّات محليّة
وعالمية، مؤمنةً بأن الكلمة تغيّر العالم.ولديّ آلاف المتابعين، الذين يدفعونني لمواصلة المسيرة.
فلنكتب بنبض القلب، ونزرع في الأطفال حبّ القراءة، لنُنشئ جيلًا قارئًا، مفكّرًا، يحلم ويصنع المستحيل.


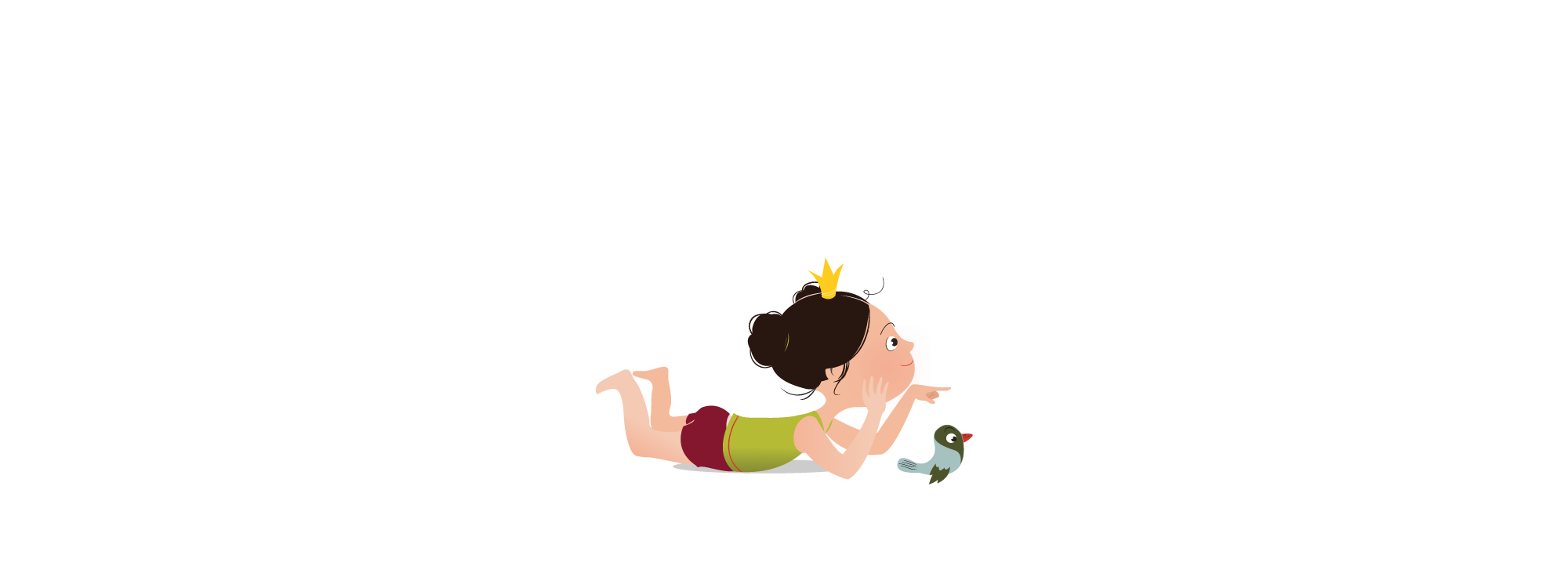


تعليقات (0)
إضافة تعليق